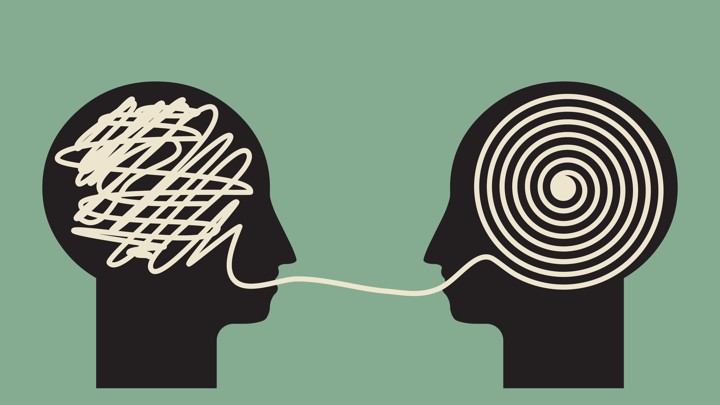طارق عزيزة*
في السنوات القليلة الماضية شهدت ألمانيا ازدياداً ملحوظا ًفي نسبة أنصار التيارات اليمينية ذات النزعات العنصرية الكارهة للأجانب. وبحسب دراسة أجرتها جامعة لايبزيغ نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإنّ نحو ثلث الألمان، لا سيما في ولايات شرق البلاد، يتبنّون أفكاراً معادية للأجانب، وهو رقم كبير ومؤشّر خطير، يشرح السبب الحقيقي وراء مشكلات وصعوبات عدة تعترض حياة اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا عموماً، وفي ولاياتها الشرقية على نحو خاص.
من البديهي أنّ أولئك المعادين للأجانب ليسوا في وارد بناء علاقات اجتماعية أو مدّ جسور للتواصل الودّي مع اللاجئين مطلقاً. لكن السؤال الذي ينبغي التفكير فيه، ماذا عن ثلثي الألمان الآخرين أي النسبة الأكبر من الشعب الألماني؟ بماذا يمكن تفسير صعوبة نشوء علاقات ودية بين معظمهم وبيننا كلاجئين أو قادمين جدد، وفي حال نشأت بالفعل علاقات كهذه، فما هو سبب فشل الكثير منها سريعاً وعدم استمرارها؟ أغلب الظنّ أنّ جزءاً من الإجابة يكمن في الفروق الثقافية وما قد ينتج عنها من سوء فهم بين الجانبين، ويمكن بيان ما سبق من خلال مواقف عملية بسيطة تزخر بها الحياة اليومية في العلاقة مع المحيط، كجيران السكن مثلاً، حيث أنّ بعض التفاصيل التي قد تبدو صغيرة ومن الأشياء “العادية”، يمكن أن تحمل دلالات سلبية من منظور الطرف الآخر، وهذا كثيراً ما يترك أثراً سلبياً يؤثّر على العلاقة برمّتها.
الجيرة الحسنة
أحد الأمثلة التي وقعت فعلاً، أن جاراً ألمانياً بادر جاره اللاجئ بالتحية ورحّب به وقدّم له بعض المساعدة عند انتقال الأخير للسكن في الشقة المجاورة له، وهذا القادم الجديد بدوره بادله الودّ وشكره بهدية أو دعوة إلى الطعام، وصار الاثنان يلتقيان من وقت لآخر. ثمّ بعد فترة وجيزة تغيّر سلوك الجار الألماني نفسه تجاه جاره اللاجئ، وبات تواصله معه في حدوده الدنيا، مما أثار استغراب الأخير واستهجانه. فهل تحوّل الجار اللطيف فجأةً إلى شخص “عنصري” و”نازي” كاره للأجانب، كما قد يسارع بعضهم إلى القول؟
الجواب لا، فالسبب ببساطة، هو استياؤه ممّا اعتبره قلّة احترام له ولحقوقه، من خلال ما يقوم به الجار وضيوفه من خرق متكرّر لأوقات الهدوء والراحة شبه المقدّسة في هذه البلاد، والتي تعدّ من أكثر أسباب الخلافات بين الجيران شيوعاً، حتى أنّ القانون ينظمها نظراً لأهميتها ويفرض غرامات على المخالفين عند وجود شكوى، كفترة الظهيرة بين الواحدة والثالثة، أو ساعات الليل ما بعد العاشرة ليلاً وكذلك أيام الآحاد.
المشكلة أن لدى الشخص قناعة بأنّ له مطلق الحرّية في بيته، ليفعل فيه ما يشاء وقت يشاء –وهذا على الأرجح ما كان عليه حاله في موطنه الأصلي- دون اعتبار لراحة الجيران، وينسى أنّه الآن في مجتمع تحكمه اعتبارات مختلفة، وينبغي عليه مراعاة أوقات الهدوء واحترامها، ليس من باب الأدب واللطف وحسن الجوار فحسب، وإنما التزاماً بالقوانين والأنظمة التي تفرض قواعد واضحة في هذا الخصوص، وإن بدت لا تخلو من بعض المبالغة أحياناً.
الاهتمام بالبيئة ليس ترفاً
لا يقتصر سوء الفهم مع الجيران على الأمور المتعلقة بالإزعاج الشخصي، وإنما يمكن لمسائل ذات طبيعة عامة أن تؤدي إلى مواقف سلبية كالوعي البيئي مثلاً، ومن أبرز تجلّياته في ألمانيا عملية فصل النفايات المنزلية بهدف تسهيل إعادة تدويرها. فهذا الموضوع أضحى من البديهيات لدى الألمان بوجه عام، ولا يقتصر التقيّد بهذا السلوك البيئي على نشطاء حماية البيئة أو حزب “الخضر” مثلاً، وإنما هو ثقافة عامة في المجتمع الألماني، خلافاً لبلدان معظم المهاجرين حيث تكاد تنعدم الثقافة البيئية، والاهتمام بها يبدو ترفاً لمعظم الناس. وبالتالي، يمكن لاختلاف أولوياتٍ كهذه أن يرخي بظلاله على العلاقة بين الجانبين، فيكون موقف الألماني من جاره اللاجئ الذي لا يتقيّد بهذا السلوك البيئي سلبياً ويؤثّر على حسن التواصل بينهما، علماً أن لا شيء شخصيّاً بينهما، لكن طريقة السلوك التي اعتادها كلّ منهما فرضت نفسها.
الكلب فرد من العائلة
ويمكن أن يقع سوء الفهم الناجم عن الفروق الثقافية حتى بين الأصدقاء، وأيضاً نتيجة ردود فعل أو سلوكيات يظنّها بعضنا عاديّة أو غير ذات قيمة، لكنّها بنظر أصدقائنا الألمان بالغة الأهميّة، مثل طريقة التصرّف أو التعليقات الخاصّة بالموقف من الحيوانات المنزلية، وخاصّة الكلاب. ليس من المبالغة القول أنّهم يعدونهّ فرداً من العائلة، وله احترامه والوقت المخصص له. في المقابل ثمة فئات منّا ليست بالقليلة تنظر نظرة بالغة السلبية إلى الكلاب خصوصاً، وذلك لاعتبارات دينية بحتة، ولن يكون وقع ذلك جيداً لدى أصدقاء هؤلاء من الألمان الذين لديهم كلاب.
إنّ الفروق الثقافية ليست مشكلة في حدّ ذاتها وإنما تصبح كذلك عندما تسود حالة متبادلة من قلّة أو حتى انعدام المعرفة الجيدة بما يمكن تسميته مجازاً “ثقافة الآخر”. ولا حاجة إلى الخوض في إشكالية تحديد الثقافة وتعريفاتها المختلفة، فالمقصود هنا بعض العناصر الثقافية التي تتضمنها مختلف التعريفات السائدة للثقافة، من قبيل العادات وأنماط السلوك وسلّم القيم والأولويات لدى الأفراد أو الجماعات التي ينتمون إليها.
ولا بدّ من التأكيد أنّ ما سبق، وإن تناول المسألة بوجه عام، إلا أنّه في الوقت نفسه لا يرمي إلى التعميم وإنما لإثارة الانتباه إلى ما قد تسببه الفروق الثقافية من سوء فهم بغية تجنّبه أو إزالة الالتباس حوله، عوضا ًعن التسرّع في إلقاء التهم أو تعزيز الصور النمطية المغلوطة تجاه “الآخر” المختلف.
*طارق عزيزة. كاتب سوري من أسرة أبواب
اقرأ/ي أيضاً: