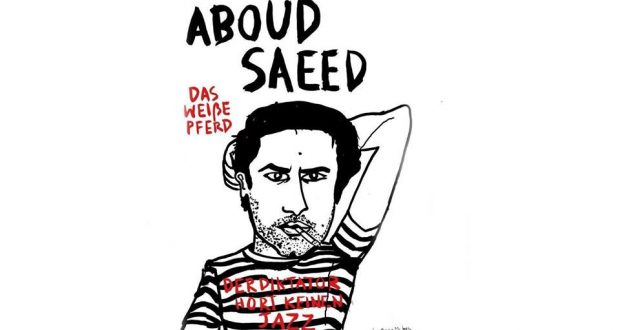وجدان ناصيف
“بالتأكيد سأعود بس تخلص بسوريا”، جملة يرددها الكثير من السوريين اللاجئين بدون الخوض في التفاصيل: ما هي التي سـ ” تخلص” ؟ وكيف سيعود؟ وإلى أين؟ كلها أسئلة يتم التهرب منها. أي جواب يعتبر فاتحة لأسئلة ليس اللاجئون أو النازحون من يمتلك جوابها، بل هي خرجت من أيديهم جميعاً، كما يعترف معظم السوريين بما فيهم البسطاء.
ينتظر عادل أن يعود لمخيم اليرموك، وحتى حينها هو يؤجل كل شيء؛ تعلم اللغة، البحث عن عمل، وحتى التعرف على الأماكن الجميلة حوله، فهذه البلاد لم يحبها وهي “لا تناسبه” كما يقول. يدعو أبو صابر الرجل الثمانيني الذي هُجّرَ من بيته في حي التضامن إلى منطقة قريبة، أن يؤجل الله أخذ أمانته حتى يعود في بيته. ومثلهما تنتظر سمر وغيرها العودة إلى حلب أو دير الزور أو داريا أو يلدا في ريف دمشق. الكل ينتظر أن تأتي لحظة يعود فيها إلى حيث كانت حياته تجري بصورة عادية قبل أن يبدأ فيلم الرعب الطويل.
هل أنا حقاً هنا ؟ لا، لا بد أنه كابوس، كل ليلة، عندما أذهب للنوم، أستحضر عمداً صوراً من ذاكرتي أكاد أفقدها، أسماء تلاميذي في المدرسة، رائحة الطبشور على أصابعي، تفاصيل بيتي؛ الباب الحديدي الأخضر الذي نال إعجاب زوّاري، ولون السيرامك في أرضية مطبخي وترتيب صحون الطعام في خزانته، والمشجب في زاوية غرفتي ولون معطفي والشالات الملقاة عليه، ألعاب أطفالي، ورنة صوت جارتي وهي تنده لي لتناول فنجان قهوة. تفاصيل أخشى كل يوم أن تنسيني إياها هذه البلاد، فأقاوم. وأبقى أقاوم.
ليست هذه البلاد أجمل من بلادي، لكنها “بلاد المطر” يا أبو طلال
في بلاد غرقها المطر.. وبلادي عطشانه
وفي بلاد سيّجها الفرح. وبلادي عتبانة..
نادراً ما نلتقي نحن السوريون بدون أن نخوض في حوار تحكمه المقارنة والتفضيل. بلادنا مناخها أفضل، الناس فيها طيبون، التعليم فيها أفضل، الطب، الطعام.. الخ. المقارنة تصل بنا إلى طعم الفواكه والخضار التي اختزنتها ذاكرتنا. المبالغة تأتي من الحنين، والتفضيل يأتي كنوع من المقاومة. مقاومة الوقوع في هوى بلاد “المطر” تبدو شرطاً لعدم نسيان بلاد العطش “العتبانة”.
تقول لي طبيبة الأسنان المهتمة بالشأن السوري بعد تعليقها على تصريحات الأوربيين حول الحل السياسي مع أو بدون الأسد: ” هل ستعودون إلى سوريا؟ ” ثم تتابع قبل انتظار الجواب: ” ماذا عن الأولاد وتعليمهم؟ ” “أليس من الأفضل أن يبقى الأولاد هنا حتى لا تضيع منهم سنوات أخرى في محاولة التأقلم بين عالمين ولغتين وطريقتي تعليم؟ إن بقيوا هنا ألن يصبح هذا البلد وطنهم؟ ربما سيعودون لكن فقط للزيارة، أليس كذلك؟”.
في كل لحظة أطرح على نفسي هذه الأسئلة، أتذكر كيف تبلغتُ خبر إطلاق سراحي. خلال دقيقتين فقط تكثفت أمامي كل السنوات وكل الألم والذل والقهر. دقيقتان احتقرتا عمراً ووشمتاه للأبد بــ “الخسارة”.
يومها ما أن دخلت مكتب الضابط حتى أمرني، بدون أن ينظر في وجهي، أن أجلس على الكرسي الذي وضع منفرداً في وسط مكتبه الكبير والفخم. بقي للحظات يقرأ ملفاً في يده دون أن ينظر اليّ، ثم نطق بعد دقائق: “هذه هويتك؟”. انتظر اجابتي، وفهم إنّني لا أستطيع تمييزها عن بعد الأمتار الثلاثة التي تفصل بين كرسيي ومكتبه، ثم قال: “اقتربي”. أمسكتها بلهفة واستغربتُ صورتي التي لم تعد تشبهني. قلت:” نعم هي بطاقة هويتي”، ومددت يدي لكي أعيدها له، لكنه قال: “خذيها واخرجي من هذا الباب”! و أشار لباب يفضي إلى فناء فرع التحقيق العسكري.
وقفت أمامه واجمة وكأنّ قدميَّ ثبتتا بالأرضية. قلت له إنّي لم أفهم، فكرر الجملة ذاتها، وبذات الاستهتار واللامبالاة.
“بهذه البساطة؟” سألته. هز رأسه اشارة إلى أنّه لم يفهم قصدي، فقلت:”إن كان خروجي بهذه البساطة، خذي هويتك وامض لماذا إذاً سجنتموني كل هذه السنوات، وكيف ستعيدونها لي؟”.
يومها كان مرسوم قد صدر بإطلاق سراحنا أنا ورفيقاتي، قرار شخصي من الأسد الأب، مثلما كان قرار اعتقالنا والاحتفاظ بنا لسنوات قراراً شخصياً منه.
يحدث أحياناً ان نتحمل الخسارة من اجل تغيير ما، لكن ماذا لو كانت الخسارات بلا مقابل كما يبدو للمتابع للواقع السوري اليوم.
أتخيل أحياناً أنه لو حدث وقالوا للاجئين فجأة: “خلصت” بسوريا على طريقة عادل، “خذوا أمتعتكم وعودوا”، سيقرر الكثيرون العودة، لكن في تلك اللحظة ستصعد كل الأسئلة المؤجلة وتنبت لها أشواك، سيتكثف كل الألم والخسارة والفقدان والوقت المهدور. قبل أن يعودوا، سيضطرون للخوض في تفاصيل كانوا كل الوقت يتجاهلونها لأن لا أحد يمتلك الجواب مثلما أن لا أحد اليوم، وحتى الذين يفاوضون عنهم، لا يعرفون ” كيف ســتخلص”، ماذا عن الإعمار والتنمية ؟ ماذا عن سنوات الذل وهدر الكرامة؟ ماذا عن رحلات اللجوء والرفاق الموتى؟ ماذا عن الأولاد الذين لم يتعلموا العربية، وقد بدؤوا بنطق الحروف وتعلمها في بلاد اللجوء؟ ماذا عن هناك؟ ماذا عن الأحبة الذين رحلوا؟ ماذا عن المفقودين ؟ ماذا عن…. وعن… ؟
تخيلوا أن يُترَك آلاف، بل مئات آلاف السوريين ليدخلوا قراهم وحاراتهم ومدنهم؛ سيبحثون عن بيوتهم، ولا يجدونها مثلما كانت في مخيلتهم. لن يجدوا شيئاً مما حفظته ذاكرتهم؛ لا الثياب ولا المشاجب ولا السيراميك على الأرضيات ولا الفاكهة “الغير” ولا الخضروات المختلفة، وربما لن يجدوا سوريا التي يرددونها كل ليلة قبل النوم، ليثبتوا لأنفسهم أن ذاكرتهم عامرة بها، بأسماء الشوارع والحارات والمحلات والمقاهي وبياعيّ الشاورما والمسبحة..
لا زلت أذكر كيف وقفت أمام الباب الذي أشار لي الضابط للخروج منه، لا شيء معي إلاّ بطاقة هوية عليها صورة لم تعد تشبهني. وقفت هناك أنتظر رفيقات سجني، فقد كنت غير قادرة على أن أخطو بدونهن، خرجن واحدة تلو الاخرى تفصل بين خروجهن دقائق طويلة. وقفنا ننتظر صامتات بدون أن نتكلم عن عجزنا عن المضي خطوات بعيداً عن الفرع، وبعدها صرنا أكثر وأكثر، وكان رجال الأمن كلما زاد عددنا يطلبون منا الابتعاد، لكننا كنا ملتصقات بالمكان، بقينا نتنظر لساعات حتى اجتمعنا كلنا وقد صرنا مطرودات فعلياً من فناء الفرع وحتى من الشارع الذي يفضي إليه. بعدها كان علينا أن نودع بعضنا ونمضي كلٌ إلى مصيرها المنفرد.
ما أشبه اليوم بالأمس، وكم هو مؤلم أن نعيش في عمرٍ واحد ذاتَ التجارب التي تتكرر بنفس مقدار شدة الألم لمرات ومرات، وبذات الاستهتار واللامبالاة من الآخرين. أتخيلها أمامي لحظة العودة؛ لن ينتظر أحدُنا أحد. سنمضي منفردين لكي نقف على عتبات خساراتنا، سنفتح غرف العزاء لمن فقدناهم وسنفتش عن مصير غيرهم وستزدحم صورهم أمامنا وسنوشم بوشم الخسارة من جديد وسيكتب عنّا:
مثل حبات المطر
لا يعرفون شيئاً عن مصير الهطول
ليتهم كانوا أرضاً
أو.. ليتهم بقوا غيمة.