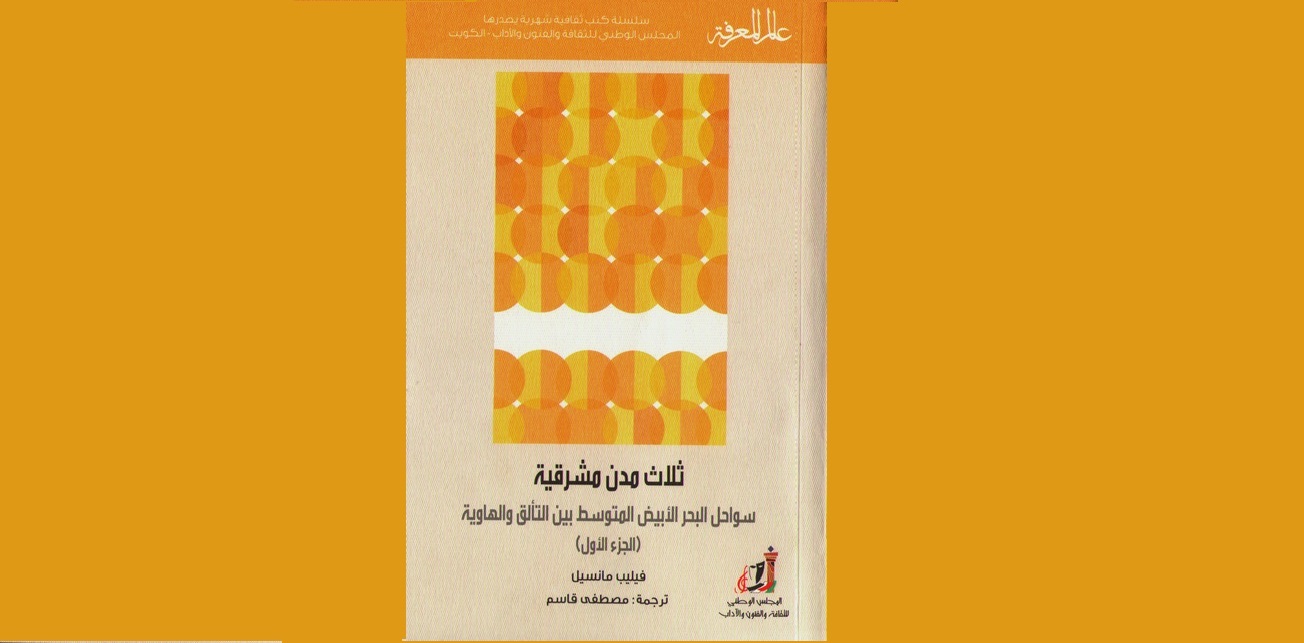جهاد الرنتيسي*
يعود المؤرخ البريطاني “فيليب مانسيل” في كتابه “ثلاث مدن مشرقية” إلى مناخات شواطئ البحر الأبيض المتوسط بين القرنين السادس عشر والعشرين بحثاً عن أرضيات ملائمة لمدّ الجسور بين “المشرقية” والعولمة.
ويحاول عبر رصده لأنماط الحياة والتحولات في “ثلاث مدن مشرقية” المدن البحرية الثلاث: “سميرنا/أزمير”، و”الإسكندرية” و”بيروت”، أثناء الحكم العثماني وما بعده، التركيز على التعايش بين الأعراق والأديان.
في هذه المحاولة يرسم خطاً بيانياً للصراعات الدولية والنزعات العرقية والدينية التي ساهمت بتأرجح حياة سكان هذه المدن وإمكانيات تعايشهم، وتقويض احتمالات استمرار التجربة وفرضية انبعاثها. كما يحرص على التعريف بأنماط التفكير والعلاقات الاجتماعية التي تكوّنت بفعل التركيبة السكانية وأنماط الحياة الاقتصادية وإفرازاتها الطبقية.
محاولات التجسير في كتاب “مانسيل” الصادر في جزئين عن سلسلة “عالم المعرفة” اصطدمت بأجزاء من الصورة التي رغب في أن تكون وافية. فإحدى الحقائق التي خدشت فكرة التجسير تمثلت في معطيات نشوء المدن “المشرقية”، والتي كان أبرزها التقارب السياسي والمصلحي بين الدولة العثمانية وفرنسا، مما يقلّل من أهمية البعد “التعايشي” في دوافع تطور هذه المدن ومشرقتها، بمعنى آخر جاء التعايش الصوري نتيجة لتوجّه سياسي أملته المصلحة، ولم يقم على التفاعل بين أعراق وقوميات مختلفة اختارت أن تبني عالماً تعددياً وتعيش فيه.
قد تكون الصراعات الدموية التي اندلعت بين المكونات العرقية والدينية خلال تلك العقود، التضاد الهوياتي الذي صاحب التجربة، والمآلات التي انتهت إليها مظهراً ونتيجة للهوة الفاصلة بين معطيات النشوء والظواهر الناجمة عنه. على هذا تترك شمولية الصورة التي سعى إليها المؤلف دافعاً للقيام بمراجعات لصور نمطية حول زمن ما بين القرنين السادس عشر والعشرين، وهامشاً للخروج باستنتاجات ترجّح وجهات نظر في قضايا خلافية.
من بين هذه الاستنتاجات أن تلك الـ “ثلاث مدن مشرقية” تبدو الأكثر قبولاً للآخر والأقدم في حال مقارنتها بالغرب، فقد تجاورت المساجد والكنائس رغم التوترات التي كانت تحدث بين الحين والاخر، حيث افتتح أول مسجد في باريس في العام 1926 تكريماً للمسلمين الذين قتلوا من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. هناك استنتاج آخر يستحق التوقف عنده، وهو أن الانتصارات التي حقّقتها الدولة العثمانية لم تقض على هويات الأمم المغلوبة في صراعات تلك الأزمنة، مما يعني غياب القدرة على الدمج والاستيعاب الهوياتي.
لكن مثلما ظهرت المدن المشرقية نتيجة توافق سياسي بين الدولة العثمانية وفرنسا، انتهت التجربة بفعل ظروف سياسية، ففي تركيا تلاشت كوزموبوليتانية “سميرنا” مع انتصارات “مصطفى كمال أتاتورك”، وفي مصر تراجعت مكانة الاسكندرية ومشرقيتها بمجيء ثورة يوليو 1952، وانحسرت مشرقة بيروت إلى أضيق الحدود بفعل قوة التدمير الذاتي التي وفّرها الفرز والحروب الطائفية وتدخلات الأطراف الدولية والإقليمية الحليفة للطوائف اللبنانية. فمن خلال تسليطه بعض الضوء على مظاهر النزعات العنصرية في علاقة أسرة “محمد علي” مع المصريين مثلاً يعيد الكتاب طرح الأسئلة المصاحبة لأسطورة البناء التي خلّفها حكم تلك الأسرة ومعاناة أجيال من أهل البلاد الأصليين.
تحاكي مظاهر النوستالجيا الناجمة عن التبادل السكاني بين تركيا واليونان، والرحيل الذي أعقب تحول “ثلاث مدن مشرقية” سميرنا والاسكندرية وبيروت إلى بيئات طاردة لاحتمالات التعددية، تفاصيل اللجوء الذي شهدته المنطقة خلال العقدين الماضيين، حيث يحتفظ المهاجرون بعادات المناطق التي قدموا منها، ويحاولون عيش أنماط الحياة ذاتها، يشعرون بغربة بين ابناء جلدتهم ويحملون أسماء المعالم القديمة ولا يتوانون في إطلاقها على معالم مواطنهم الجديدة.
ينطوي رهان انبعاث التجربة المشرقية في عواصم الغرب، والذي ظهر في خاتمة الكتاب، على مغامرة، فلم يزل الاستشراق حاضراً بشكل أو بآخر في التفكير الغربي، ويترافق ظهور الكتاب بالعربية مع موجات العنصرية المتزايدة في المدن الغربية بفعل تدفق مهاجرين من مناطق توتر ذات كثافة عرقية ودينية وثقافية مختلفة عن دول اللجوء. لكن فشل التجربة التي ظهرت في الشرق على أرضية سياسية يقلّص من احتمالات قدرتها على إعادة التبلور في الغرب، وتبدو فرص الدولة المدينية الجامعة لكل الأعراق والأديان التي وردت في أكثر من موضع ضعيفة، وذلك مع تسارع حالة الاصطفاف والفرز الديني والعرقي.
* كاتب وباحث أردني
اقرأ/ي أيضاً: