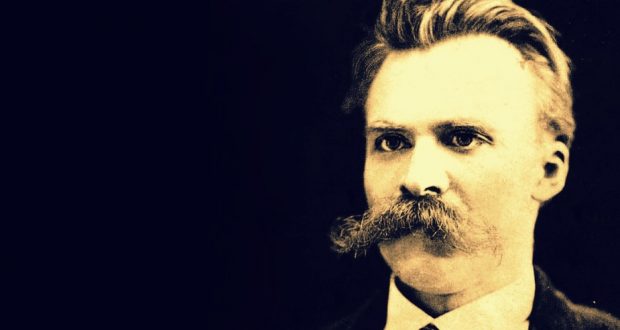عمر قدور*
ظهرت بعد الثورة محاولات لإعادة النظر في الثقافة السورية السابقة عليها، هي بمجملها محاولات قليلة، لم يخلُ بعضها من أسلوب صادم، وحالف بعضها الحظ فأخذت قسطاً من الجدال.
كذلك كانت هناك محاولات متسرعة لتأريخ الثقافة السورية فيما بعد الثورة، ولم تغب المزاجية عنها أيضاً، سواءً بالاحتفاء بأسماء محددة بلا سند نقدي واضح أو الاحتفاء بأية كتابة تجهر بانتماء صاحبها إلى الثورة، أو الطعن بما أُنتج بعد الثورة بذريعة غلبة اعتبارات السياسة عليه والتضحية بالاعتبارات الفنية.
يمكن لنا في هذا السياق استرجاع مقارنات مفتعلة، مثل المقارنة بين نزار قباني وسعدالله ونوس للقول بأن الثاني نال أكثر من حقه إعلامياً بدعوى قربه من سلطة الأسد، وبالطبع ما يبرر هذا القرب هو الاعتبار الطائفي الذي لا يتوفر في حالة قباني. وإذ لا نستطيع تنزيه سلطة الأسد عن اللعب على الوتر الطائفي ماضياً وحاضراً إلا أن المقارنة بين نزار وونوس لا تستقيم من دون الإشارة إلى الشعبية الواسعة للأول ونخبوية الثاني، وإلى أن الكاتبين حقّقا انتشارهما الأوسع انطلاقاً من بيروت لا من دمشق.
وينبغي على نحو خاص تفحّص النص السياسي لديهما، حيث لا يصعب اكتشاف ذلك الهجاء السياسي المرسل على نحو عام، ومهما بلغت شدّته يبقى في إطار من العمومية بحيث لا يشتبك مباشرة مع سلطة الأسد أو أية سلطة عربية محددة. هذا النوع من الكتابة لم يكن يقتصر عليهما، بل كان سمة شبه عامة لكتابات المرحلة كلها، وكان ضمن الحد المسموح به الذي لا يعرّض صاحبه للمخاطر.
ربما كان من حسن حظ الماغوط أنه توفي قبل الثورة، فنحن لا نعرف ما الذي سيكون عليه موقفه فيما لو عاصرها. في كتابات الماغوط وفي جزء كبير من سيرته ما يوحي بأنه لا بد أن يكون مع الثورة، لكن فيهما أيضاً ما قد يوحي بخلاف ذلك، فالرجل قبِل وساماً من سلطة بشار، وقبِل أن تُحرّف مسرحية له لتصبح هجاءً وردحاً لانتفاضة الاستقلال اللبنانية التي تلت اغتيال الحريري، أي أنه سار بخلاف ما توحي به كتاباته، مع التنويه بأن انتشار الماغوط أتى أيضاً من بيروت ولم يكن لإعلام البعث والأسد أي فضل فيه.
الإشارات الأخيرة لا تهدف إلى وصم الماغوط، ففي حالة مشابهة رأينا زكريا تامر ينحاز إلى الثورة، مع أنه كان قبلها قد عاد من منفاه ونال أيضاً وساماً من بشار الأسد، بل ساهم بكتابة مقالات في جريدة الثورة تهاجم انتفاضة الاستقلال اللبنانية، وتتناول رموزها بأسمائهم وبسخرية مبتذلة لا تليق بتاريخ الكاتب. أيضاً هذه الإشارة لا تهدف إلى وضع الرجل تحت المقصلة، ولا تجريده من أخلاقية انحيازه إلى الثورة السورية، وهذا بمجمله يبقى خارج حديث آخر يخص الجانب الفني في أدبه.
بعيداً عما هو شخصي؛ ألم تؤثر كتابات هؤلاء وأمثالهم في أجيال لاحقة؟ ألم تكن تلك الكتابات تُحسب مناصرة لقضية الحرية؟ في ظني أن الإجابة ستكون بـ”نعم”، والمقصود هنا المعنى المتعدد والعام للحرية، فضلاً عن أن قسماً من هذه التجارب يُعدّ تأسيسياً، سواءً على صعيد لغة الكتابة أو البناء الفني، أو على صعيد الاستفادة من مدارس أدبية وافدة مثل الرمزية وقصيدة النثر.
لكننا لا نغفل في المقابل أن هذه الثقافة برمتها كانت محكومة بأجواء القمع العام شديدة الوطأة، وفي حين كان يُنظر إلى المثقفين كنخبة بمسؤوليات مضاعفة فقد كانوا مثل غيرهم ضحايا الاستهداف والخوف معاً، والقلة التي واجهت السلطة الأسدية كانت بغالبيتها الساحقة منضوية ضمن تنظيمات سياسية معارضة.
في مجمل الأحوال تشترط النظرة السائدة انسجاماً بين الثقافة والمثقفين، الأمر الذي لم يكن موجوداً دائماً، ولا في العديد من المجتمعات، ومن المرجّح أنه يحتاج إلى قدر عالٍ من الحرية أو الإحساس بها يصعب توفره في بلادنا، حتى مع افتراض البدء سريعاً بالتحول الديموقراطي.
عندما نتحدث عن حقبة طويلة من الحكم الأسدي من المهم التوقف عند حقيقة أن الأسدية تملك مناعة أصيلة إزاء الثقافة، وأنها على نحو جليّ لم تنتج أسماء ذات وزن في الأدب والفن. حتى الأسماء الألمع في الحشد الفكري الأسدي، التي ظهر موقفها بعد الثورة، نالت شهرتها وحضورها من الوجود والتفاعل خارج نطاق سيطرة الأسدية.
إن من الدلالات الكبرى تراجع موقع دمشق كإحدى العواصم الثقافية بالمقارنة مع مدن عربية أخرى، وذلك الجهد الذي كان يبذله كتّاب سوريون للوصول إلى الإعلام ودور النشر في تلك العواصم، لأن الطريق الوحيد المتاح في الإعلام الأسدي هو التحول إلى بوق بالمعنى المباشر للكلمة.
ذلك لا يعفي الثقافة السورية برمّتها من المساءلة، إذ كانت في جزء منها ثقافة خوف. كان كاتب هذه السطور قد شبّه النقلة التي حدثت عام 2011 بأنها انتقال من المجاز إلى الثورة، فالمجاز بالمعنى المُشار إليه هو نوع من التقية الفنية والفكرية، ووفرة استخدامه لم تكن لأسباب فنية كما هو الأصل في المجاز عموماً.
لقد كانت وظيفة المجاز خلال عقود القمع هي التستر على المعنى والاكتفاء بالإيحاء به، وهذا تحديداً ما تحبّه أنظمة الاستبداد لأنه وهو يلمّح إليها يظهر عاجزاً عن تسميتها أو الإشارة إليها بوضوح؛ إنه نص يلمّح إلى حريته بينما يُشهر خوفه. وعندما نتحدث عن مساءلة ثقافة الخوف بهذا المعنى فالمقصود بها أولاً مساءلة كاشفة لمؤثراتنا الثقافية، من أجل المضي في ثقافة أكثر حرية، وسيكون من سوء الفهم أو خبث النوايا استخدامها على نحو شخصي، أو كمن لا يفعل سوى نبش قبور الموتى والتنكيل بهم.
يلزم أن ندع الموتى يرقدون بسلام، وإلا لن نتسامح إطلاقاً مع الأحياء. هذا يعني أيضاً أن نتسامح، بلا ادّعاء بطولات وهمية، مع خوفنا الماضي، خوفنا جميعاً كسوريين، وإن سُجّل لبعضنا كسر حاجز الخوف ودفع ثمن ذلك. النقد بهذا المعنى لا يمكن أن يُبنى بنوازع الانتقام، ولا بمحاكمة كتّاب محددين بأثر رجعي، ومنح أوسمة لآخرين بالطريقة ذاتها.
مثلاً يستحق شاعر مثل نزار قباني التوقف مليّاً عند قدرته الهائلة على تطويع اللغة، وقدرته في زمنه على الخروج عن البلاغة التقليدية؛ نحن مدينون له بلغة تُنسينا استثنائيتها لفرط بساطتها، وتجعلنا نتسامح مع أسوأ نصوصه على الإطلاق فنياً وهي نصوصه السياسية.
من المفهوم أيضاً في زمن الثورة أن ينسب البعض لنفسه سلطة إطلاق الأحكام بدون أدوات نقدية، يستوي في ذلك من يطلق نار مسدسه على الماضي بلا تمحيص في ظروفه وتياراته الثقافية العريضة، ومَن يطلق نار مسدسه على كل ما كُتب بعد الثورة بدعوى غلبة المباشرة من دون النظر في الظروف الدموية التي أدت لأن يتحمل قسم من النصوص مشقة الإقناع بأحقية الثورة، وبالتأكيد لا يخرج عن هذا الإطار من يستعجل منح أوسمة أو تطويب كتّاب بدعوى تمثيلهم الثورة.
على صعيد متصل؛ لن تغيب الشكوى السورية القديمة من كتّاب أخذوا فرصاً “لا يستحقونها”، وإذا كان لرغبة الخارج في التعرف على السوريين وثورتهم فضل في إتاحة المزيد من الفرص فربما علينا الانتباه إلى أن الأصل في الأمر هو توفر الفرص، بما في ذلك توفرها للأقل كفاءة، بخلاف ما كانت تفعله السلطة الأسدية من تضييق شديد في الفرص واحتكار القليل منها لعديمي الكفاءة. هذا هو فحوى وجود ما يراه النقّاد أدباً رديئاً وآخر جيداً، مع وجود “مستهلِك” لكليهما سواءً على سبيل التسلية أو المزاج أو المستوى الثقافي.
الآن، بعد سنوات من انطلاق الثورة، ربما يتعين علينا إيجاد صيغة ثقافية من التسامح والقسوة معاً، إذا جاز التعبير. التسامح تفرضه عقود من القمع ومن ثم سنوات من الوحشية المطلقة، والقسوة يفرضها نقد يطال قدرتنا على تقديم اقتراحات فنية جديدة، بمعنى القدرة على تمثّل الحرية فنياً لا أخلاقياً فحسب، وهذا بالتعبير الإسلامي “فرض كفاية” إذ لا يعقل مطالبة كل فرد به. وإذا كانت الثورة، كما سبقت الإشارة، انتقالاً من المجاز “بمفهوم التستر على المعنى” فربما آن الأوان لإعادة التفكير في المفهوم الأرقى له، حيث يكون المجاز جسراً بين معنيين، وحيث على هذا الجسر تتوالد معانٍ ودلالات إضافية، ويتكون ذلك التحريض على توليدها. بالطبع استخدام مفردة “المجاز” هو مجاز آخر، يصعب اختزاله بقول من نوع: إن أدواتنا جزء من حريتنا، بها نُغْنيها وبها نُفقرها.
خاص أبواب
اقرأ أيضاً: