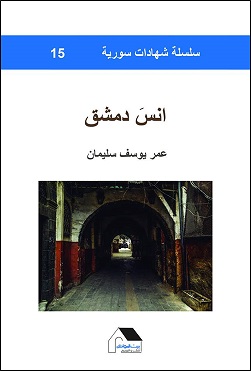نيرمينة الرفاعي | روائية أردنية
انسَ دمشق، الكتاب الخامس عشر من سلسلة شهادات سورية، طبع عام 2015 بدعم من منظمة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وسأنوّه في البداية إلى أنّه قد يكون طبع أيضًا دعمًا للمدافعين عن حقوق المدن، عن حق دمشق في الذكرى، وحقّها في سرد يومياتها تحت العنوان الفرعي “يوميات الثورة والحرب والمنفى”، فدمشق موجودة في المنفى أيضًا، هي لا تترك ساكنيها بعد أن يغادروها، تبقى تحفر بأظافرها صخر أيامهم، دمشق المتغلغلة في الروح حتى عظمها، أسيكون لها نصيب من الذاكرة أم من النسيان في آخر الكتاب المزين غلافه بأحد شوارعها؟
تبدأ الحكاية بعد عام من الثورة، خروجًا من حمص، وصولاً بالسرّ إلى “قدسيا”، ثم إلى “مساكن بزرة”، وليس انتهاء ب”جرمانا”، حالة من “الاشتراكية” عمّت المدن التي تقاسم ناسها مساكنهم وطعامهم وشرابهم، بل وفي وقت المداهمات كانوا يتقاسمون الخوف أيضًا، لكل امرئ نصيب منه، يزرعه في قلبه بذرة صغيرة حتى تكبر، ثم يدع الأغصان لاحقًا تميل إلى حين يميل الضوء في المدن المعتمة، وهكذا وجد عمر يوسف سليمان نفسه يتتبع الورد على شرفات دمشق وهو يغادرها مرغمًا للمرة الأخيرة في آذار، 2012، ومن “نصيب” حيث صودرت بطاقاتهم السورية ووتم الترحيب بهم بالقول:”أهلا بكم، أنتم الآن لاجئون لدينا”، إلى “مخيم الرمثا” الذي غادره إلى “باريس” التي سهّلت به، فتاهَ في الشوارع خارج الزمان والمكان، محكومًا بلعنة الذاكرة.
يعود الكاتب عامًا إلى الوراء، تتدفق الأفعال المضارعة إلى الوراء لترى البقعة السوداء التي لم ينتبه إليها من صرخَ بالحرية في بدايات 2011، ففي “سوق الحميدية” و”القلعة” كانت أعداد الجنود تكفي لاعتقال نصف سكّان دمشق، وعلى الرغم من الاعتقالات والمراقبة الأمنية وأخبار المجازر وكرسي التعذيب الذي كان يراه في نومه فقد طغت حلاوة كحلاوة “الراحة الدرعاوية” التي اشتراها من العجوز أمام الجامع الأموي على حديثه الحار عن الحرية.
يوميات عمر يوسف سليمان في الثورة مليئة بالتفاصيل، الهروب والاختباء وتخطيط الشعارات بيد الأمهات، يأخذ بيد القارئ يشدّها أصبعًا أصبعًا ليؤلمه ويسمع صوت طقطقة مفاصله وهو يشرح له كيف انتقلت الثورة من السلمية إلى حمل السلاح..
يقتبس عن عتيق الرحيمي وسعدالله ونوس والأساطير اليونانية وعبارات الحجاج بن يوسف الثقفي، وبلغته السردية السلسة يتنقل بين الأماكن والشخوص دون تكلّف، في صفحة تتمشى في متجر في باريس ثم في الصفحة التالية تبكي لمشهد ساحة في الرقة علقّت فيها داعش رؤوسًا بلا أجسادها، ويدخل في مقارنات سريعة مفزعة بين حدائق لوكسمبورغ التي شيدّت فوق أنقاض قصور الدكتاتوريات القديمة وبين الحدائق في “الوعر” و”تلبيسة” و”الرستن” التي تحولت إلى مقابر للشهداء، وتكاد تسمع الرعب والقلق في صوته على مستقبل سوريا القادم.. وتيرته في الكتابة تحتد وتعلو ثم تهبط بحزنها المختمر كامل النضج، تتحول الكلمات إلى حديد بارد كقضبان السجن خلال وصفه لزيارته بدعوة من مدير “بيت الشعر” في مدينة “فيرساي” لسجن “بواسي” الفرنسي حيث تقيم المؤسسات الثقافية زيارات دورية للسجناء، ثم يتوه خيال الكاتب في شوارع ستراسبورغ ويضيّع اتجاهاتها، ثم يضيق بحصار اسمه الذي تجاذبه الأجداد ليمزقوه بين “عمر بن الخطاب” و”عمر بن عبد العزيز” و”عمر أبي ريشة” و”عمر بن ابي ربيعة” و”عمر الشريف”، ليصبح اسمه الحقيقي سورًا غير مرئي يفصله عن ذاته، سورًا يبلغ باللغة الفرنسية مقدار جملة كاملة، وسورًا يحمل باللغة العربية فوقه عبارة “أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله” ويسبب له المشكلات في أغلب الأماكن..
عودة إلى البداية، يتساءل عمر يوسف سليمان في الصفحة 10: “رأسي يبعد عنهم مترًا واحدًا، ألا يرون ما بداخله من خراب”؟ وهنا يدور برأسي الذي يبعد عن رأسه الآف الكيلومترات كيف أستطيع أن أرى الخراب يمشي بين السطور دون أن تقتنصه ولا حتى رصاصة واحدة!
بوجع عينيه اللتين تريان الأشياء مضاعفة أو مقسومة يستذكر مشاهد الدم الاوّل في الثورة، “تطفئه الحبوب المنومة كما ينطفئ التلفاز، يكتئب كثيرًا، ويدخن أكثر من قطار قديم”، هكذا تمرّ أيام عمر في المنفى
هذا الكتاب وصف حيّ لخراب المدن والبشر وصمود الذاكرة أمام زوال الجغرافيا، ولا أعلم ما مدى قدرة الكاتب على نسيان دمشق بعد أن كتبها بهذا الشغف! يقول عمر: “المنفىّ يعود ولدًا”، ويؤكد على أنَّه لن يكون حرًّا إلّا إن نسي دمشق، أنسيها إذن؟ لا أعلم، ولكنني أرى بين السطور أولادًا يركضون في الحارات بأقدام عارية تتلمس التراب كي لا تنساه أبدًا، وأستذكر في نفس الوقت بيت محمود درويش وهو يقول:”كم أنت منسي وحرّ في خيالك”، هل ارتبطت الحرية بالنسيان حقًّا؟