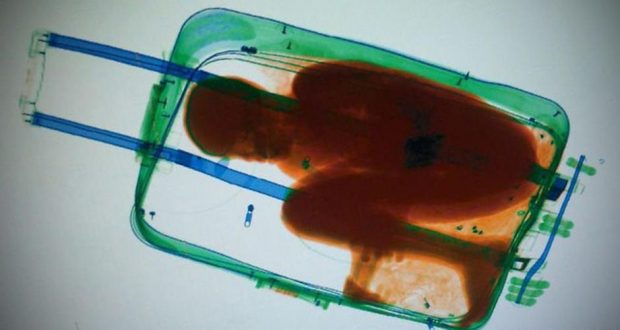منصور حسنو*
لم يأت اللاجئون السوريون وغيرهم إلى أوروبا هروباً من أنظمة ديكتاتورية ودول قهرية فحسب، بل كذلك من مجتمعات محكومة بأنظمة معرفية وثقافية شمولية. وكما تتعرض تلك الأنظمة الديكتاتورية لهزات وشكوك تتعرض المجتمعات بالتزامن معها إلى هزّات تفقدها شرعيتها.
مجتمعات هكذا كان حالها وحال دولها لا بدّ أن يكون المرء فيها حاملاً بعض الأمراض والعقد النفسية، وكما يتأثر المرء صحياً عند التنقل بين مناخين مختلفين، كذلك هو الحال عند الإنتقال من الدول الديكتاتورية إلى الدول الديمقراطية.
تنتشر في أوساط الإسلاميين في الشرق فكرة تتلخّص بأنّ مجتمعات الغرب منحلّة أخلاقياً، يتمرّد فيها الأبناء على آبائهم والنسوة على أزواجهم، ولذلك تجد هذه الأوساط عند وصولها إلى أوروبا أنّ الخلاص هو في تجنب أشياء مشابهة قد تحدث لعائلته في المستقبل، والحل هو في تعزيز تواصله مع المسجد وإرسال أولاده إليه، فهل تقوم المساجد بدورها في حفظ العائلة وتحقيق التوازن النفسي والإجتماعي مع المحيط الجديد؟
غياب حرية الرأي والتعبير، والتي لم يعرفها اللاجئون إلا سماعاً في كتب المناهج الدراسية في بلدانهم، خلق جيلاً من المقموعين والمكبوتين، فإذا ما عبّر أحدهم عن رأيه السياسي أو الاقتصادي المخالف لرأي الحزب الحاكم كان مصيره الإعتقال والتعذيب. هذا الوضع بالغ السوء في بلداننا أجبر المقموع أو المكبوت على الانفجار ما إن يصل إلى بلد الحرية، فيبدأ بالصراخ برأيه دون حسيب أو رقيب. هذه الحالة سمحت للمكبوت دينياً في وطنه السابق أن يقوم بالتعويض عما كان محروماً منه في السابق كما يقول كارل يونغ. لذلك يجنح بعض المتدينين من السوريين في ألمانيا لإعتناق الأفكار السلفية، التي كانت محظورة في بلدانهم، كما كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة، وهنا يكون يتعمّق دور المسجد في تكريس هذا التوجه، خصوصاً إذا كان المشرفون عليه أيضاً يتبنون المنهج السلفي في تدينهم.
عندما تكون في بلد يحترم الحريات الفردية والجماعية فإنّك أمام جدلية معقدة، كأن ترى من يجد في هذه الحرية وسيلة لنشر أفكاره ودعوته التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية! أو أن تكون في بلد تشكّل قوانينه السبب الرئيسي والملزم لأن تعيش فيه بكرامة وسلام، ثم تعتبر أن قوانين الشريعة يجب ان تصان وهي أكثر صحة من قوانين الغرب! كما حدث مع بعض الجماعات الإسلامية في الغرب عندما شكلت مجموعة أسمتها: شرطة الشريعة، أو جماعة أخرى في الدنمارك خرجت تنادي بالخلافة وهي ترى الإيمان بالديمقراطية كفراً بواحاً!
لا شك نحن هنا أمام مشكلة عويصة قد تهدّد قيم الدولة الحديثة، ناهيك عن استعصاء مثل هذه النماذج والشرائح عن الإندماج في المجتمع الجديد.
بكافة الأحوال فإن أسلوب التلقين وغسل الأدمغة الذي تمارسه بعض المساجد، بحجة الحفاظ على الهوية الإسلامية وحماية الأطفال من الإنحلال، سيخلق جيلاً قد يكون بعض أفراده صيداً ثميناً للمنظمات الإرهابية المشبوهة، والتي أجزم أنّ مناخ المساجد السلفية هو البيئة المناسبة لعملها ولمهامها المنوطة بها. هذا يتطلب من المؤمنين الحذر والتنبه على أنّ ما يخافون على أولادهم منه قد يقعون فيما هو أسوأ منه. وبناء عليه يجب التركيز والتوجيه، خصوصاً لمن يرغبون بتعليم أولادهم المعتقدات والأخلاق الدينية. يجب الحرص على الإحاطة بالمناهج التي يتلقاها أولادهم، وطبيعة المشرفين عليهم في المساجد، فالتعصب أو التوجيه السلبي أو الدعوات التي تحضّ على كراهية الآخر والتمييز بين مؤمني الأديان المختلفة يجب أن تواجه بصوت عال، حرصاً على مستقبلنا وإيماناً بأنّ جوهر الأديان قام لأجل المحبة والسلام.
وكمثال على ذلك، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحجيب الطفلات الصغيرات والقاصرات، ممن هن في المرحلة التأسيسية من التعليم الإبتدائي، وهذا يعني وجود توجه ديني طارىء على الأهالي يقوم بزييف وعيهم الديني، بحيث يتمظهر هذا التزييف بأشكار وصور تعكس سلبية الثقافة الجديدة الوافدة إلى أوروبا.
الحرية قيمة القيم ولكن هذا لا يعني أن نجعلها وسيلة لنشر ثقافة التلقين والإكراه والتخويف، بحيث أنّ ما هربنا منه في بلداننا الديكتاتورية نساهم بخلقه في بلداننا الديمقراطية، ونحن الكبار لم نسلم من عقدنا وأمراضنا التي حملناها معنا فما ذنب هؤلاء الأطفال أن يحملوها أيضاً؟
نعم لحرية المعتقد والإيمان، ولكن المعتقد والإيمان الذي يقوم على المحبة والسلام مع النفس ومع الآخر. لقد فتحت الكنائس في ألمانيا أبوابها لمساعدة اللاجئين، وساهمت في إقامة دورات في تعليم اللغة وترجمة أوراق طالبي اللجوء وعقد جلسات حوارية وتقديم الطعام للمحتاجين ومشاركة الحوارات والشاي والقهوة، فالكنيسة الغربية الحديثة تجاوزت الأفكار المسبقة البالية، وصار الإنسان محور رسالتها ومركز اهتمامها كائناً من كان، وليس مهماً ما هو الدين الذي يحمله.
ربما تكون المساجد قادرة على تطوير برامجها وخطابها، فليس مهماً فقط أن تفتح أبوابها للزائرين في عيد الوحدة الألمانية، بل سيكون أكثر تأثيراً وفاعلية إن فتحت آفاق رؤيتها اللاهوتية للحياة وللإنسان.
*منصور حسنو – كاتب سوري
اقرأ/ي أيضاً: