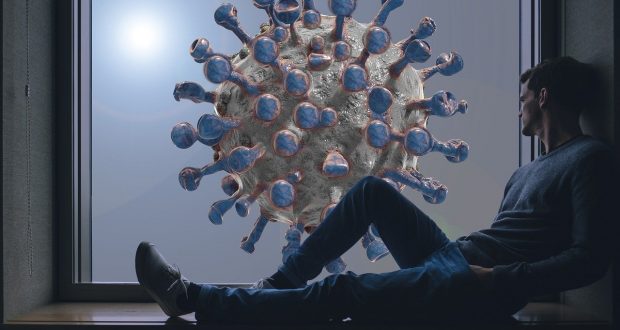لا تجد صديقتي التي تعيش الإقامة الجبرية في منزلها، شأنها شأن معظم سكان الكرة الأرضية هذه الأيام، أي صعوبة في التعايش مع عزلتها. حتى أنها تستمتع بها بكل جوارحها؛ فقد سنحت لها فرصة حقيقية لتعيش ثانيةً حصار شهر كامل في مدينتها الصغيرة في حياتها الماضية.
تقف مطولاً على نافذتها المشرعة على الساحة المهجورة حيث لا أحد ولا شيء يمر أمامها، سوى الطيور التي احتلت الشارع بكامله وأخذت تتنقل فيه بحرية مذهلة وكأنها هاربة من الإقامة الجبرية وتعود بذاكرتها سنوات إلى الوراء وتفكر:
ها نحن الآن مسجونون في منازلنا من جديد، ولكن مع فارق بسيط، وهو أننا بأمان من القصف والمداهمات العسكرية. نبقي نوافذنا مشرعةً على الهواء الطلق دون الخوف من الرصاص. لا نقلق من الجوع أو البرد لأنه لدينا ما يكفينا من الماء والكهرباء والغذاء وحتى الإنترنت. نتجول في كل أنحاء المنزل دون الاضطرار للنزول إلى القبو خوفاً من القصف. نتواصل بسهولة مع بعضنا بشكل دائم ونحن منتشرون في كل أنحاء المعمورة، ولسنا مضطرين لانتظار المساء حتى نصعد إلى منازلنا ونتكلم على الهاتف الأرضي، الوسيلة الوحيدة التي بقيت لدينا حينها للتواصل مع العالم الخارجي، مع أحبائنا ومعارفنا لنعرف من بقي منهم على قيد الحياة.
عند الثامنة مساء ستفتح صديقتي نافذتها لتصفق وتحيي الطاقم الطبي في المستشفيات الذي يرعى صحة المواطن، وحتى يخاطر بحياته لمساعدة المرضى. وستبتسم بينها وبين نفسها وهي تتذكر كيف كانت تهرع من نافذة إلى أخرى الساعة الحادية عشر ليلاً لتصرخ بأعلى صوتها” الله أكبر”، هذه الجملة التي كانت تزعزع أمان رجال المخابرات كونها تتحدى النظام وجبروته وقوته وتذكره بمن هو أكبر وأقوى.
يقطع تفكيرها مرور رجل في الشارع الفارغ أمامها وهو ينزه كلبه -من الأسباب النادرة للخروج من المنزل- لتجد نفسها تتساءل فجأة: كيف ستكون علاقتنا مع الحياة ومع بعضنا في حال بقينا في زمن ما بعد الكورونا هل سيكون للحياة طعم آخر؟ هل سيسود الحب والتعاطف بين الناس بعد هذه المحنة القاسية؟ هل سنرجع كما كنا أم سنتعلم دروساً حقيقية؟
تعترف صديقتي أنها لم تعد متأكدة من شيء، سوى قناعتها أن لكل إنسان الحق في اختيار الطريقة التي تساعده على تجاوز هذه الأزمة. البعض يشعر بالحنق والغضب من كل شيء، آخرون يأخذون الأمر بعبثية سوريالية كاملة، والبعض الآخر يتجه نحو الجدية والحزم والمنطق المفرط، وآخرون تنتابهم موجة غير متناهية من الحب للجميع، والكثير الكثير منا يعيش رعباً قاتلاً من الموت.
عندما تراود صديقتي فكرة الموت، تتذكر حين كان يقترب القصف من منزلها وتضطر للنزول والاختباء في القبو، منتظرةً الموت في أي لحظة. كانت تعزي نفسها بفكرة أنها ستموت شهيدة، وأن الشهيد سيأخذ معه إلى الجنة عشرة أشخاص، وتبدأ تعد الأشخاص الذين ستأخذهم معها إلى الجنة. تفاجئ نفسها عندما تفكر أنه في تلك الأيام كان للموت معنى وقيمة، من الجميل أن تموت في سبيل حريتك وكرامتك وإيمانك بمبادئ وقيم. ولكن من الغباء والسخف الشديدين أن تموت من الكورونا.. (ببياخة) وهنا تتساءل: هل سبب الموت يعطيه قيمة؟ أم أن الموت واحد في كل الأحوال؟
ما بعد الكورونا
على كل حال الموت لا يقلق صديقتي، لأنها تعتقد أن الإنسان يبدأ بالحياة الحقيقية عندما يتخلص من خوفه من الموت، وهذه هي الحرية. وهنا تتذكر الكتاب الرائع لخوسيه ساراماغو (تناوب الموت)، الذي يصف فيه بلداً لا اسم لها يتحقق فيه حلم البشرية الأزلي: الخلود. اختفى الموت، لم يعد له وجود، ولكن بدأت مشاكل عديدة من الاختفاء المفاجئ للموت، حتى أصبح الأهالي يتمنون رجوعه حلاً للكثير من هذه المشاكل.
رواية (تناوب الموت) رواية غير عادية تذكرنا بأيامنا الحالية، حيث لم يعد هناك وجود لأي شيء عادي. حتى مرور الزمن أصبح غير عادي. لاحظت صديقتي أنه بينما توقفت عجلة الحياة عن الدوران، يمر الربيع بالخارج بسرعة مخيفة، أوراق الشجر تكبر ساعةً تلو الساعة، وكأن الوقت يمارس وظيفته خارجاً فقط وكأنا نحن المنسيين في الداخل قد تاه عنا الزمن. هل فعلاً نسينا الزمن على حافة الكورونا؟ هل سيمر الربيع بالخارج دون أو نشعر به؟ وماذا لو أتى الصيف بدون أن يمر الربيع علينا؟ وماذا لو تعاقبت الفصول وبقينا نحن المنسيين في الداخل؟
د. نعمت أتاسي. كاتبة سورية تحمل دكتوراه في الأدب الفرنسي ومقيمة في باريس
اقرأ/ي أيضاً:
زاوية يوميات مهاجرة 15: شجرة أمام نافذتي
زاوية يوميات مهاجرة 14: طابور الحياة…
زاوية يوميات مهاجرة 13: باريس وأبوابها السبعون …!