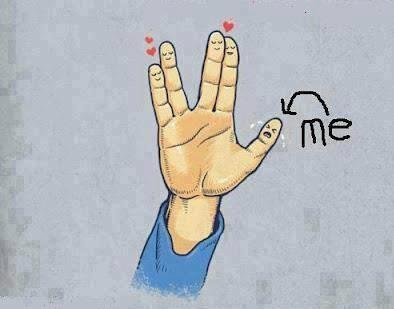فادي جومر
منذ الصباح الباكر وأنا أستعد لفعل شيءٍ لا أعرف ما هو حقيقةً!
اليوم عيد الحب، وأنا اللاجئ القادم من بلاد ذاع صيت عشاقها الذين “فشلت” قصص عشقهم، فصاروا شعراء “ملوّعين” و “ملوّحين” وكان لا بد لي من المشاركة في الاحتفال بما يتناسب مع تاريخ عشاق بلادي.
قاومت الفكرة لأسباب ماورائية غامضة، وبدأتُ فورًا بإجراءات الأمان:
عرّجت -كعادتي حين أرغب بالغرق في الكآبة- على أخبار القصف الأممي على بلدي، الأحمر يغطي أهلي لأنهم “أحبّوا” الحرية!، أليس هذا المشهد بالمجمل: عيدًا ومعشوقةً وهديةً تناسب هذا الزمان؟؟
تفقدتُ كلّ “البروفايلات” التي أحببت صاحباتها، أهديتهن جميعًا ذات الصمت، وأذهلني انتشارهن المرعب في كل أرجاء الأرض، أي تاريخ أسود يلفّ قلبًا يعشق كلّ هذا الشتات؟
شيئًا فشيئًا، تكوّرت في زاوية الغرفة وبدأت ملامحي بالتحوّل إلى شخصية يتلبّسها الجنّ في فيلم مصريّ من السبعينات، حتى أنّ شريكي في الغرفة بدأ يفكر جدّيًا بطلب الإسعاف. وأنا أزداد تشبّثًا بكآبتي المصنّعة ذاتيًا.
فجأةً!، مرَّ عاشقان جميلان من الشارع الذي أمضي وقتي الثمين في مراقبة خلّوِه، عاشقان بوردتين، تحت المطر الناعم، في يوم (الفالنتاين)! أي صخرة كآبة تصمد أمام سيل الفرح في ملامحهما؟
عدتُ لوعيي، وانتصر الواقع على الميتافيزيقيا المعششة في هرائي. بحثت عن أي احتمال، لأي صديقة تشعر بالملل عساها أن ترافقني إلى أي مكان –حتى لو كان إلى مركز توزيع المساعدات الغذائية– وكنتُ متفائلاً إلى حدٍّ ما، فكل الذين أعرفهم تقريبًا من القادمين الجدد، يعانون الوحشة والضجر في انتظار إتمام اجراءاتهم، أو يبحثون عن متنفسٍ أيام العطل من ضغط دراسة اللغة، والحديث عن الإحباط والملل هو الشكوى شبه اليومية للجميع! إذن، ثمّة فرصةٌ طيبةٌ بأن أجد رفيقةً أكسر معها برود الغربة، نتسكع في الشوارع، نشاهد “الحب” و “الأحباب” وربما نهدي وردة لثنائي ما، ونتقاسم الفرح.
تحوّلت ووسائل اتصالي كافّةً إلى غرفة عمليات، فلم تكن الخطّة الخروج في موعدٍ خاص، ما يعني أنه كان من الممكن أن نكون “شلّة”، اتصلتُ بكل من كنّ يشكتين من الكآبة والوحشة والملل في الأسبوعين الأخيرين، واقترحت “مشوارًا” بلا هدفٍ على سبيل كسر ذات الكآبة والوحشة والملل، وانتظرت إجاباتهنّ، فكانت كالتالي، وكانت ردودي أيضًا: كالتالي.
- “الجو بارد!”
- هل أنتظر الصيف؟
- “لا أرغب في الخروج!”
- أجل، البيت يساعد على الترفيه!
- “ربما في يوم آخر”
- في عيد الشجرة ربما.
- “مكتئبة!”
- هل أدعوك لجنازة لتحسين مزاجك؟
- “ماذا تريد بالضبط؟”
- أريد أن أستدين منك ثمن الـ “بيتزا!”
- “أحتاج إلى ساعتين لأصل إلى قريتك”
- وساعتين للعودة! انسي الموضوع.
- “عندي امتحان بعد شهر ونصف”
- كم أنت مهملة! كيف تتركين دراستك لتردي على اتصالاتٍ تافهة؟!
- “لقد خرجتُ الآن من الحمام”
- اللعنة! علينا أن ننتظر يومين لـ “يزيّت” شعرك!
- “مممم لا أعرف في الحقيقة إن كنتُ مشغولةً!”
- هل أتواصل مع مدير مكتبك؟
- “لن تنطلي عليّ خدعتك!”
- لم أجد جوابًا، ولكن راودتني رغبة جامحة بالعودة إلى ما تحت القصف.
يبدو أنيّ محكوم بالإحباط!
على طاولة المطبخ المكتظ بالأشياء التي تنتظر أن “تُجلى” بصحبة “أركيلتي” القميئة، وثلاثة أرباع قارورة ساخنة من الفودكا الرخيصة، وتفاحتين، ولابتوب يلفظ أنفاسه، وأغنيات مليونير ملتحٍ يغني للفقراء: أمضيت يوم عيد الحب في ألمانيا.