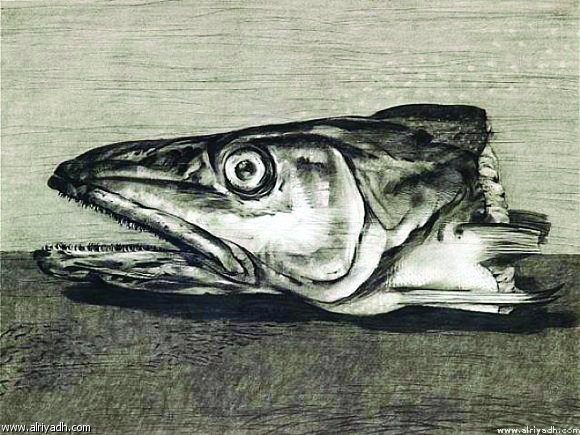على خلاف معظم المواضيع المعاصرة، تحتاج الكتابة في العلمانية إلى اجراءات خاصّة. لأنّ العلماني –كما يجزم خصومه– له صفات سلوكية وفكريّة ثابتة، لا يمكن أن يكون علمانيًّا إذا أغفلها.
بداية، خلعت ملابسي، فالتعري والعلمانية توأم سياميّ، بغض النظر عن الطقس ودرجات الحرارة، وعن الكتل المتدليّة من خاصرتي و”كرشي” والتي تجعلني عادة شغوفًا بالشتاء، كارهًا للصيف لأن الملابس الشتوية تستر “البلاوي”. ولكن الكتابة في العلمانية تحتاج لهذه التضحية.
وكان لابد لتكتمل الطقوس، من بضع زجاجات من الخمر على الطاولة، فالعلماني سكّير بالضرورة، وهو يكاد لا يصحو من سكره، حتى لو كان مصابًا بالقرحة والسكّري. لا علمانية بلا كحول، هذا ثابت لا خلاف فيه.
وقد لا يسمح المقام هنا بالإسهاب في الطقوس الجنسية المنحرفة التي لابد منها لكل علماني.. لذلك، سأترك هذا التفصيل لخيال القارئ، وهو خصب بما يكفي، وزيادة.
وقد يقتضي الأمر أن يمارس القارئ –ذو الخيال الخصب– ذات الطقوس ليتمكن من قراءة مادة تتناول العلمانية من وجهة نظر إيجابية والعياذ بالله.
لنترك قشور العلمانية التي تدعو لقيم سطحية كالمواطنة، والعدالة، والتعامل مع الإنسان كـ إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو القومي أو الإثني، والتي تتيح لأي شعب اختيار نمط الحكم الذي يناسبه، والقوانين التي يريد أن يخضع لها عبر الآليات المملة كالبرلمان والبيانات الانتخابية، وما شابه من هذا الهراء، وتضمن وقوف الدولة على مسافة واحدة من كل مواطنيها، وعدم منح أي امتيازات أو انتقاص أية حقوق لأي مواطن، فكل هذه القشور لا تسمن ولا تغني من جوع، للعلمانية غايات أهم وأسمى، لا يعرفها إلا أعداء العلمانية. لأن العلمانيين البسطاء مخدوعون ببساطة.
في عمق العلمانية، كما يخبرنا خبراء النظم الشموليّة، دينيّة كانت أم أيديولوجية، تكريس لإنسانية الإنسان، وتقديس غير مقبول لفردانيته وحقوقه، ومساواة غير مفهومة بين البشر، كيف يمكن لعاقل أن يقبل أن تعامل الدولة أعضاء الحزب الحاكم كأي مواطن آخر؟، أو أن يتمتع اللاديني، أو المؤمن بدين مغاير للدين السائد بذات الحقوق؟ أترضاها لشعبك؟
وفق معايير العلمانية، سيكون مثلاً من حق أي مواطن الترشح لأي منصب سيادي، حتى ولو كان هذا المواطن من أقليّة دينية أو عرقية، أو حتى لو كان مهاجرًا حاصلاً على الجنسية، تخيل أن نجد في بلادنا وزيرًا أو رئيس وزراء من أصول غير قحطانية أو عدنانية، كما يحدث في الدول العلمانية المسكينة، حين نجد وزيرةً فرنسية من أصول مغربيّة، أو رئيسًا أرجنتينيًّا من أصول سورية.. أي شرّ هذا؟
آن لنا أن نعرف حقيقة العلمانية، وأن نضع حدًّا للمعجبين بقشورها، وأن نعريها أمام الجماهير المنساقة وراء شعاراتها البراقة، التي ما أفادت الشعوب التي طبقتها شيئًا، إذ أن الفارق الواضح بين المجتمعات التي تحكمها الأنظمة العلمانية، والمجتمعات التي نجت من هذا الوباء، لا يترك للمنظّر العلماني فرصةً للدفاع عن قضاياه الخاسرة. فالمجتمعات العلمانية غارقة في انحلالها، غير متوازنة، مستضعفة، تحترم حرية كلّ الأديان، وحتى حرية اللادينين، وتحمي المرأة والطفل، فهل هذا ما نريده حقًا؟ ولماذا نغامر بتجربة منظومات جديدة للحياة والقوانين، وأمامنا عشرات التجارب الناجحة للدول التي لا تجرؤ العلمانية على الاقتراب من حدودها، فالرفاق الحزبيون، أو رجال الدين، حسب المتوفر في كل بلد، يقفون بالمرصاد لهذا المنهج التخريبي، ويبذلون الغالي والنفيس لصون بلادهم من هذا المرض العضال. والحفاظ عليها حيث هي اليوم: رمزًا للحياة الرغيدة ونموذجًا للتفرقة التي تحفظ للناس مقاماتهم فلا يتجاوز لاديني مقام مؤمن.. ولا ليبراليّ مقام شيوعي.
ختامًا..
كنت أتمنى أن أسهب أكثر في بحثي هذا، ولكني أكاد أتجمد من البرد، وارتداء ملابسي سيمنعني من متابعة البحث بطبيعة الحال. عسى أن أعيش يومًا في بلاد استوائية دافئة أكتفي فيها بسروال داخليّ من القش وأتابع فيها ما بدأت.