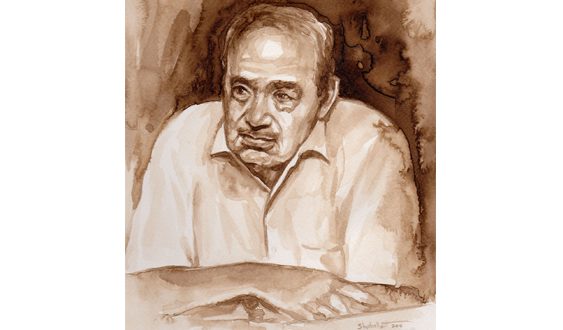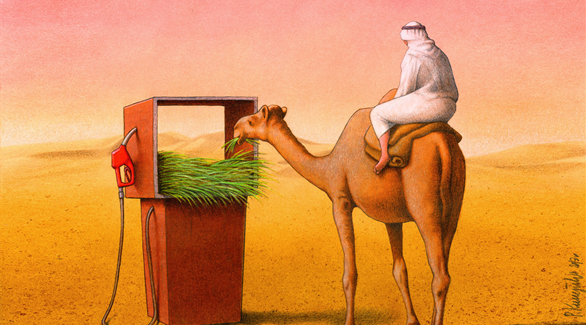مصطفى علوش
أنا المدعو “مواطن عربي سوري” وتولدي كان بين نكبة حزيران ونكبة التصحيح، ولولا القدر الإيجابي لكنت الآن في خبر كان، والسبب “حتى لا تذهب بكم الظنون إلى البحر المتوسط الذي كان يراقب موتنا بين اليونان وتركيا” يعود إلى الهلع الذي كانت تسببه لي ابنة لاجئ آخر تقاسمت معه الغرفة التي دللناها وقلنا عنها “كرفانة” فهذه الطفلة اللطيفة كانت تنام وتجلس وتلعب على السرير الفوقاني ووالدها اللطيف جدًا ينام بالسرير التحتاني، وأنا وبقية عائلتي ننام على ثلاثة أسرَة، كانت تلك الطفلة اللطيفة تحب القفز من أعلى السرير نحو الأرض، ووزنها حسب تقديري بحدود الستين كيلو غرام، في المرة الأولى كانت الدنيا نهارًا وبعد استيعابي التكتيكي لصدمة قفزتها قلت لها: يا صديقتي نحن هنا خمسة في هذه الكرفانة، الرجاء أن تنزلي نحو الأرض بسلاسة، يومها ابتسمت ابتسامة صفراء تشبه تمامًا كلمة “اخرس ولاك”.
في اليوم التالي عادت وقفزت ليلاً بعد إنهائها لكل متابعاتها الفكرية على الواتس آب، حيث يمكنني الاستنتاج أن توصيات والدتها تتلخص من خلال مراقبتها الكبيرة لوالدها، أنا كنت نائمًا ومع لحظة القفز انتفضت كمريض صدمته كهرباء العمليات الجراحية، وعندما اكتشفت أنَي بخير قلت “لا حول ولا قوة إلا بالله”! أما هي فابتسمت ضاحكة، ويومها انتظرت حتى نامت تمامًا لأنام بعدها، والآن أحمد الله أني على قيد اللجوء الإنساني والحياة، حيث تمكنت بعد أيام من تغيير سكني وتركت تلك الطفلة اللطيفة تقفز لوحدها.
طبعًا في هذه المرحلة من اللجوء تكون هذه التفاصيل الحياتية أهم من كل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية السورية التي دونتها على حبر النسيان، فالحصول على حمّام فارغ صالح للعمل في النهار مثلاً يعتبر إنجازًا شخصيًا، وفي إحدى المرات كاد لاجئ آخر أن يخلع الباب عليَ وأنا في قلب العملية “الاستحمامية” وهو بالخارج يصرخ عليَ بدأ معي تحقيقًا فحواه “ما هي الأسباب التي جعلتني أغلق باب الحمام الخارجي؟ وكنت أحاول تمرير الوقت أمام زحمة أسئلته وخلال ثوانٍ أنهيت حمامي وخرجت طالبًا السلامة الشخصية.
أحلف لكم بماء البحر المتوسط ومعه بحر الشمال والأحمر أنَي لا أبالغ، وطبعًا هناك مقالب ضاحكة لا يمكن أن أغفل عيني عنها، فأنا شخصيًا أعيش حياتي لأمجد النصف الممتلئ من الكأس، ومن هذه المقالب قصة ضحكة أحد أصدقائي اللاجئين، فهذا الشخص يمتلك ضحكة لو سمعتها أنجيلا ميركل نفسها لقالت لأجل هذه الضحكة فتحت أبواب ألمانيا أمام اللاجئين، فهو يضحك على مراحل فأول الأمر ينذر مستمعيه حيث يصدر صوتًا تمهيديًا مميزًا، بعد ذلك يبدأ بتقسيم ضحكته إلى مراحل ويصعد، يصعد، يصعد إلى أن يصل إلى مرحلة التلاشي والانطفاء.
لاجئ آخر يعيش معنا يقلد الآخرين جيدًا تمكن من معرفة الشيفرة الوراثية وصار يقلد ضحكة صديقنا الأول، وصار كلما غاب الأول نطلب منه تقليده فيضحك مثله تمامًا، ولولا أن الأول قصير القامة، والثاني طويل، لقلت إنه هو نفسه بكل شيء.
في الكامب أيضًا كان أحد اللاجئين يعتقد أن هناك طائرة تراقبنا، طائرة نعم، حيث كانت تمرَ بعض الطائرات في سماء المنطقة، هو كان يراقب عبور الطائرات ووصل إلى تلك القناعة الحربية الأمنية، فعلقت قائلاً: نعم هذه الطائرة تراقبنا فهي تعدً الوجبات الثلاث التي نتناولها هنا، وربما تعرف عدد المرات التي شربنا فيها القهوة في صالة المطعم وربما سائقها مولع بالتلصص على النساء! أو ربما الطائرة تصور وثائقنا عن بعد، أي عن طريق الأقمار الصناعية، فكل شيء وارد، وأظن أن هذه الطائرة تراقبك أنت تحديدًا!
لاجئ آخر تعرفت عليه أيضًا وأسرَ لي أنه متزوج من ثلاث نساء وعنده 16 ولدًا، الزوجة الأولى أنجب منها ابنتين واختلف معها فطلقها بسبب أمها الثرثارة “الله يسامحها” قال لي، ومن زوجتيه أنجب 14 طفلاً، وعندما سألني عن عدد أولادي هربت من سؤاله نحو مواضيع من عيار البعد الجمالي في لوحات فاتح المدرس التشكيلية! وحتى اللحظة أذكر عذوبة جوابه بعد حديثي عن لوحات فاتح المدرس وهو يقول: الأولاد زينة الحياة.
لاجئ آخر وبعد نقاش سياسي عويص عن الوضع السوري علق خاتمًا حديثه: النظام يحتاج إلى شوية إصلاحات! ومع آخر كلمة له طلبت منه فتح نوافذ الغرفة من أجل التنفس.
ومن باب التفاؤل أقول هنا الحياة فعلاً لا تطاق فمن غير المعقول أن لا تنقطع الكهرباء، ومن غير المعقول أن لا يكون عند الألمان فروع مخابرات ومجلس وزراء يعقد جلسات نوعية وبعد كل جلسة نوعية هناك مئة برميل يهديها “جيش الوطن” مجانًا لعدد من المناطق، فشخصيًا أعتقد أنه على الألمان التعلم من خبرة حكومة النظام النوعية.
وحتى أختم بتفاؤل أقول معقول بلد بكامله متل ألمانيا ما فيه فصل صيف! أي بسوريا الصيف صيف، وعلى حد قول الحمامصة حاجي عاد.
كاتب سوري